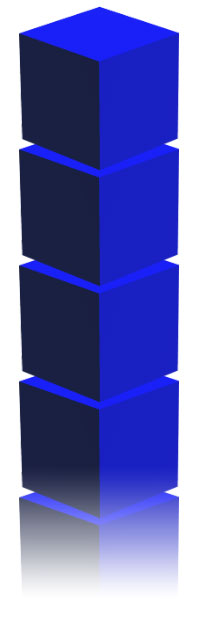!!! ما الفرق
بزغ وطلع
"وتَرى الشّمسَ
إذا طَلعت تزاورُ عن كَهفِهم
ذاتَ اليمينِ وإذا غَرَبت
تقرِضُهم ذاتَ الشّمال
وهُم في فجوةٍ مٍنهُ"الكهف
"وَكَذَلِكَ
نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ
(75) فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ
اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا
قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا
أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ
الْآَفِلِينَ (76) فَلَمَّا
رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا
قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا
أَفَلَ قَالَ لَئِنْ
لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي
لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ
الضَّالِّينَ (77) فَلَمَّا
رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً
قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا
أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ
قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي
بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ
(78)
لم قال عن الشمس في الآية
الأولى: طلعت، وفي الآية
الثانية بازغة؟
ما الفرق
بين الطلوع والبزوغ؟
وهل
يجوز أن يقول في الأولى:
(إذا بزغت )؟
وما اختلاف
المعنى إن قال بزغت؟ وما
فائدة طلعت بالذات؟
ثمة
فائدة صحية فكيف نعرفها؟
بزغ
وطلع، فعلان لهما معنى
عام وهو الظهور ولكن هناك
تخصيصا بينهما نتبين
ملامحه في قول الخليل:
نقول بزغت الشمس بزوغا
إذا بدا منها طلوع.
وكأن
الخليل يقصد أن البزوغ
أول الطلوع، وهذا هو رأي
أبي هلال العسكري صاحب
الكتاب المعروف (الفروق)
ولنبدأ
بقراءة الآيات القرآنية
التي جاء فيها هذا الفعل،
حيث قال الله عز وجل عن
نبيه إبراهيم عليه السلام
في سورة الأنعام: (فَلَمَّا
جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ
رَأى كَوْكَباً قَالَ
هَذَا رَبِّي فَلَمَّا
أَفَلَ قَالَ لا أُحِبُّ
الْآفِلِينَ76 فَلَمَّا
رَأى الْقَمَرَ بَازِغاً
قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا
أَفَلَ قَالَ لَئِنْ
لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي
لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ
الضَّالِّينَ77 فَلَمَّا
رَأى الشَّمْسَ بَازِغَةً
قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا
أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ
قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي
بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ78)
لم تقل الآيات عن الكواكب
أنها بازغة، لأن الكوكب
يظهر حين يأتي الظلام،
ولا ينتظره المرء من الأفق،
أما وصف الشمس بأنها بازغة
فيعني أن إبراهيم عليه
السلام كان يصوب ناظريه
إلى الأفق يرتقب بدء طلوع
الشمس ولم يكن يصوبه وسط
السماء مرتقبا ظهور الشمس
فُُجاءة في كبدها، والأفق
لا علو فيه، فإذا ما ارتفعت
الشمس قليلا سمي ذلك طلوعا
لأنها تشرف على الأرض
من علو .
يؤكد ذلك أن الأفق
لا علو فيه أما التوسط
ففيه علو
والفعل طلع
يتعدى بالحرف على الذي
يفيد الاستعلاء، وفيه
علو وإشراف كقوله تعالى:
(وَمَا كَانَ اللَّهُ
لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى
الْغَيْبِ179) آل عمران
وفي
قصة الفتية في الكهف قال
تعالى: (وَتَرَى الشَّمْسَ
إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ
عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ
الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ
تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ
وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ
مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ
اللَّهِ مَنْ يَهْدِ
اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ
وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ
تَجِدَ لَهُ وَلِيّاً
مُرْشِداً) (الكهف:17)
ولم
تقل الآيات (بزغت الشمس)،
بل استعملت كلمة طلعت،
وهذا يؤكد أن البزوغ أول
الطلوع، ولأن الطلوع
من فوق والبزوغ من أفق،
ولو أن الشمس كانت تزاور
عن كهفهم من بزوغها لفسد
هواء الكهف وأصابهم الأذى
بذلك ولهذا يكون المعنى
والله أعلم: أن ضوء الشمس
يدخل الكهف من بزوغها
إلى طلوعها، فيصيبهم
خيرُها ونفعُها بما فيه
صلاحُ أجسامهم قبل أن
تشتد فتمسهم بحرها. فالله
تعالى قد دبر أمرهم فأسكنهم
مسكنا لا يكثر سقوط الشمس
فيه فيحمى، ولا تغيب عنه
غيبوبة دائمة فيعفن،
فلا ترادف بين اللفظين
وهذا من دقة الاختيار
في التعبير القرآني
الهلع
والفزع
الفَرْقُ بين ”الهلع”
و”الفزع”:
أن الفزع مفاجأة الخوف
عند هجوم غارة وما أشبه
ذلك، وهو انزعاج القلب
بتوقع مكروه عاجل
ومعنى خفته أي هو نفسه
خوفي
ومعنى فزعت منه أي
هو ابتداء فزعي لأن “من”
لابتداء الغاية
وأما الهلع فهو أسوأ
الجزع
وقيل إن الهلوع فسره
الله تعالى في قوله: “إن
الانسانَ خُلقَ هلوعاً
إذا مسهُ الشر جزوعاً*
وإذا مسهُ الخَيْرُ منوعاً”
ولا يسمى هلوعاً حتى
تجتمع فيه هذه الخصال.
الخوف والوجل
الفَرْقُ بين “الخوف”
و”الوجل”:
أن الخوف خلاف الطمأنينة
وَجِلَ الرجل يوْجَلُ
وجلاً: إذا قلق ولم يطمئن،
ويقال: أنا من هذا على وجل
ومن ذلك على طمأنينة،
ولا يقال: على خوف، في هذا
الموضع،
وفي القرآن “الذين
إذا ذُكِرَ الله وَجِلَتْ
قلُوبُهُمْ” أي اذا ذكرت
عظمة الله وقدرته لم تطمئن
قلوبهم الى ما قدموه من
الطاعة وظنوا أنهم مقصرون
فاضطربوا من ذلك وقلقوا
السين
وسوف
كلمتان نستعملهما
في حديثنا عما نريد فعله
في المستقبل والفرق بينهما
أن السين للمستقبل القريب
المتوقع القدوم أما استعمال
(سوف) فيكون في المواطن
التي يتوقع فيها الشيء
بعيدا وهذا نستعمله في
كلامنا دوما
وفي استعمال القرآن
له دقة عجيبة تراعي سياق
الكلام، فتختلف الأداة
لمستعملة في آيتين متشابهتين
بسبب اختلاف سياق ورودهما،
ومقام الحال فيهما ومع
هذه الأمثلة سيتضح الأمر
أكثر بإذن الله فأرجو
من القراء الكرام التأمل
في الآيتين التاليتين:
" فقد كذبوا بالحق لما
جاءهم فسوف يأتيهم أنباء
ما كانوا به يستهزئون
" الأنعام5
" لعلك باخع نفسك ألا
يكونوا مؤمنين . إن نشأ
ننزل عليهم من السماء
آية فظلت أعناقهم لها
خاضعين . فقد كذبوا فسيأتيهم
أنباء ما كانوا به يستهزئون
" الشعراء6
نعرف أن سوف أبعد في
الاستقبال من السين
فإن قلنا : سنفعل كذا،
فهذا يعني أننا ننوي فعله
بعد مدة بسيطة قد تكون
بعد الانتهاء من الكلام
وإن قلنا سوف نفعل
كذا، فهو يعني أننا نؤجل
الفعل لمدة مستقبلية
أطول ، ففيها تأخير
وفي الآيتين السابقتين
جاءت الآية بالمعنى واللفظ
مع تغيير حرف الاستقبال،
ففي الآية الأولى وردت
سوف، وفي الثانية السين،
فما السبب؟
ـ ذكر سوف في
الأنعام يفيد تأخير العقوبات
إلى زمن أبعد وتفسير ذلك
أن آية الشعراء تتحدث
عن قوم الرسول صلى الله
عليه وآله وسلم ، أما آية
الأنعام فلعموم الكافرين
فناسب ذلك تعجيل الوعيد
لمن هم أقرب إليه من الكفار
الذين حاربوا الرسول
وكذبوه قبل الأباعد الذين
لم تبلغهم الدعوة بعد
ـ في سورة الشعراء
حديث عن الأقوام الذين
كذبوا أنبياءهم ، وبيان
عقوباتهم في الدنيا لذلك
جاءت السين إشعارا بتعجيل
العقوبة لهؤلاء كما عجل
للأقوام السابقة وليس
في الأنعام شيء من ذلك
ـ وقراءة سورة
الأنعام تظهر لنا أنها
مبنية على تأخير الوعيد
والعقوبات بخلاف سورة
الشعراء ، يتضح لنا ذلك
من مواضع عديدة نذكر منها
موضعين اثنين :
* جاء فيها أمر للرسول
عليه الصلاة والسلام
: " قل إني على بينة من ربي
وكذبتم به ، ما عندي ما
تستعجلون به ، إن الحكم
إلا لله ، يقص الحق ، وهو
خير الفاصلين . قل لو أن
عندي ما تستعجلون به لقضي
الأمر بيني وبينكم ، والله
أعلم بالظالمين " فالآية
قائمة على عدم الاستعجال
، ولذلك جاءت سوف التي
تفي التأخير
* وجاء في السورة آية
الرحمة : " كتب على نفسه الرحمة
ليجمعنكم إلى يوم القيامة
لا ريب فيه " فالرحمة تنافي
تعجيل العقوبة ، والموعد
يوم القيامة ، وهو يناسب
التأخير
شرى
واشترى
كلمتان متقاربتان
أصلهما واحد، لكنْ بينهما
تضادّ في المعنى وفي الأسلوب
القرآني
** شرى
= باع، أي بدّل السلعة ليأخذ
مقابلها الثمن
وقد وردت في القرآن
الكريم أربع مرات، كلها
بمعنى (باع) ، منها قوله
تعالى: "فَلْيُقَاتِلْ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ
الَّذِينَ يَشْرُونَ
الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
بِالْآخِرَةِ وَمَنْ
يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ
يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ
أَجْراً عَظِيماً" (النساء:74)
أي : لا يقاتل في سبيل
الله حقا إلا الصادقون
الذين يبيعون حياتهم
الدنيا لله، ليناول النعيم
الخالد في الآخرة.
ونلاحظ أن الباء (باء
البدل والمعاوضة ) قد دخلت
على المادة المأخوذة،
وليست التي تركوها.
** اشترى
= أخذ، أي قبض المادة المشتراة،
ودفع الثمن الذي معه.
وقد وردت مرات عديدة
منها: "إِنَّ الَّذِينَ
اشْتَرَوُا الْكُفْرَ
بِالْأِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا
اللَّهَ شَيْئاً وَلَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ" (آل عمران:177)
أي أخذوا الكفر، وباعوا
الإيمان، ونلاحظ الوضع
المعاكس للباء حيث دخلت
هنا على المادة المباعة
المتروكة.